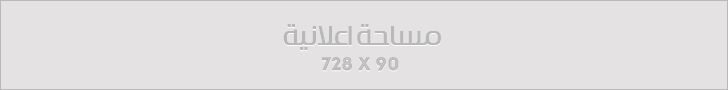المشروع النهضوي العربي : رؤية من الداخل

مدخل عام يمثل " المشروع النهضوي العربي" الذي طرحه مركز دراسات الوحدة العربية ، حصيلة عمل جماعي منظم استمر من العام 1988 ، وحين قدم للأمة في مارس منعام 2010، فإنه قدم باعتباره تمثيلا لقوى الأمة الفاعلة، إنجازاواستهدافا.
وأكدت المقدمة التي وضعت لنص المشروع هذا المعنى حيث جاء فيها " لقد حرص مركز دراسات الوحدة العربية ، منذ بداية عمله في هذا المشروع، على مشاركة التيارات الفكرية كافة في إنجازه ( من قوميين وإسلاميين ويساريين وليبراليين) حتى يأتي ممثلا نظرة الأطياف الفكرية والسياسية كافة بحسبانه مشروعا للأمة جمعاء لالفريق منها دون الآخر. ولقد كان الجميع مشاركا في المراحل كافة".
وطلب الأخ الدكتور خير الدين حسيب راعي هذا المشروع، والمحرك الرئيس لهذا الجهد المستمر والشامل، أن يكتب أصحاب الرأي والمهتمين في مختلف وسائل الإعلام حول هذا المشروع شرحا ونقدا وتفاعلا، حتى يكون المشروع حاضرا لدى نخبة هذه الأمة، وصول الى عامتها، وحتى يصبح محور حركة فكرية مشهودة تغنيه وتغتتني به. والمشروع المقدم في نحو مئة وعشرين صفحة من القطع المتوسط، يحتوي ثمانية فصول، يتضمن الفصل الأول بعد المقدمة، حديث عن ضرورة النهضة، وتجارب النهضة التي شهدتها الأمة، وعوامل الضعف والقوة فيها ودروسها، وكيفية التعامل مع ثمراتها،ثم تتناول الفصول الستة التالية ـ وهي من الثاني الى السابع ـ أركان المشروع النهضوي العربي، التي اعتمدتها قوى الأمة وجعلتها أهدافا جامعة لها وهي : التجدد الحضاري، الوحدة، الديموقراطية، التنمية المستقلة، العدالة الاجتماعية، الاستقلال الوطني والقومي، ثم جاء الفصل الثامن ليتحدث عن آليات تحقيق المشروع.
وكل تقديم لهذا المشروع وكل حديث عنه أو حوار فيه لايستقيم، ولا يأخذ حقه وأبعاده، إلا بعد الإطلاع على المشروع نفسه، والتمعن فيه، وإلا بعد إدراك حقيقة أنه يقدم نفسه حصيلة جهد قوى الأمة كلها، وبالتالي تطلعه ليعبر عن القاسم المشترك الجامع لكل هذه القوى، وإذ أقدم هنا قراءتي لهذا المشروع فإنني أدعو الجميع الى العودة أولا الى نص المشروع ـ المتوفر في موقع مركز دراسات الوحدة العربيةـ، ومن ثم قراءة ومتابعة ما يكتب فيه وعنه.
مقدمة
لايمكن فقه هذا المشروع الا بعد إدراك استهدافاته، وطبيعة القوى التي عملت على إخراجه، ومسار ولادته.
ولقد تكفلت المقدمة المكثفة التي افتتح بها هذا المشروع بتبيان ذلك، والذي يقرأ هذه المقدمة يدرك بسهولة أن هذا المشروع وضع مستهدفا قوى الأمة جميعا، ومخاطبا، إرادتها السياسية وتجلياتها الفكرية التي باتت تتمحور في تيارين عريضين غنيين بالتنوع وهما التيار القومي والتيار الاسلامي. وما يضمان من اتجاهات متعددة.
ولعل أهم تجليات هذين التيارين كشفت عن نفسها في الاستهداف الستة للمشروع الحضاري العربي، التي اعتمدت سياسيا وفكريا وهي : الوحدة العربية، والديموقراطية، والتنمية المستقلة، والعدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني والقومي، والتجدد الحضاري.
ولا شك أن عناصر المشروع الحضاري العربي الستة هذه تمثل المخرج للأمة مما هي فيه، كما تقدم بوصلة لتوجيه الحركة، وتصويبها في كل حين، واتفاق تياري الأمة على هذه العناصر يحقق انجازا مهما، ويمهد لمرحلة من التفاعل بين
التيارين يمكن أن يثمر الكثير، سواء في فهم ونقد تجارب الماضي ، أو في تفصيل وتدقيق خطوات المستقبل.
إن هم جمع الأمة على مشروع واحد، يستحق كل عناء، وهو واضح جلي في الروح العامة التي وقفت خلف صوغ هذا المشروع. واعتبار أن التيارين الرئيسين في الأمة هما التيار القومي العربي، والتيار السياسي الاسلامي، اعتبار صحيح في إجماله. وافتراض أن ما يجمع هذين التيارين أوسع مدى وأعمق بكثير مما يفرق بينهما صحيح ايضا إذا نظرنا الى الموضوع من زاوية المشروع الحضاري العام للأمة وليس من زاوية برامج العمل السياسي، وما نحن بصدد مناقشته هو المشروع الحضاري العام وليس هذا البرنامج السياسي او ذاك.
إن المقدمة العامة للمشروع تكفلت بايضاح هذا الجو العام لضرورات هذا المشروع والاحتياج اليه، وتوافق قوى الأمة على أهدافه. وفتحت الباب أما توقع ان ياتي العرض العام، والتحليل، وبالتالي الخلاصات والنتائج في هذا السياق نفسه،اي أن تكون هذه كله تعبر بحق عن رؤية متوافقه بين تياري الأمة، فهل أعطت التفاصيل بدء من الفصل الأول الى الذي جاء تحت عنوان "في ضرورة النهضة" وصولا الى الفصل الأخير الثامن الذي تحدث عن "آليات تحقيق المشروع"، إن ما أقدمه من قراءة هنا تحاول أن تجيب على هذا التساؤل والذي اعتقد أنه جوهري في توفير الحشدالفكري والحركي اللازم لمشروع يستهدف تحريك الأمة كلها.
أولا: بداية تحتاج الى مراجعة
يتوجه المشروع الى قوى الأمة الحية، ويتحدث عن الأمة العربية تاريخا وراهنا، لكنه في حديثه عن هذه الأمة يبدو على غير منهج واضح، إذ تبدو الأمة في موضع وكأنها وجود خارج صناعة التاريخ أو تعلو عليه،وإلا كيف نتحدث عن "الأمة العربية ومشروعها الاسلامي في تواريخ مختلفة من العصر الوسيط: انقسام الدولة الى أربعة مراكز( خلافة عباسية في العراق، وخلافة فاطمية في مصر، وخلافة أموية في الأندلس، وخلافة مرابطية في المغرب)".
ولا اشك أن أحدا ممن ساهم في صوغ هذا المشروع يعتقد بأن الأمة العربية كانت موجودة قبل الاسلام، أو أنه يبني مفهوم الأمة على العرق والدم، أو انه يعتقد أن الاسلام" وهو رسالة السماء الى الأرض" هو مشروع الأمة العربية. ومع ذلك فقد جاءت هذه الصياغة غير تاريخية، وبالطبع غير علمية. واتساقا مع هذا المدخل غير العلمي وغير التاريخي, جاء الحديث عن " الفكرة العليا التي صنعت الأمة وصنعت لها حضارة وسلطانا في التاريخ، ـ والتي ـ تظل ـ مع ذلك كله حية في اذهان قسم ولو قليل من ابنائها مندفعه الى استدعائها باستمرار والى الحنين اليها، ثم تدفعه الى التوسل بها مادة يبني عليها وبها طموحا أو مشروعا للنهوض من جديد. ولعل التساؤل المباشر هنا يختص في تحديد ماهية هذه الفكرة العليا، إن بالإمكان الذهاب مذاهب شتى في تحديد هذه الفكرة العليا, لكن يسبقى كل تفسير وتحديد هو محض افتراض، وهنا يخشى المرء ان تتغلف هذه الفكرة العليا بالضباب نفسه الذي تغلفت به فكرة أوشعار" الرسالة الخالدة" الذي رفعه حزب البعث حين انطلاقه.
إن هذه الصياغة في هذا المدخل وفي مواضع أخرى من نص المشروع هي اقرب الى الصياغة الأدبية الدعوية منها للصياغة العلمية، التي يجب أن تصبغ "نص مشروع النهضة " فيأتي في إطار تقريرات، ورؤى واضحة صحيحة وقاطعة، تعطي المنتمي اليه وضوحا في الرؤيا، وصحة في المعرفة، وقدرة على مواجهة المستجدات من خلال المنهج العلمي الذي بنيت عليه الرؤى التي يقدمها هذا المشروع.
ثانيا : بذور النهضة وتجلياتها الأولى :
يتفق الباحثون من علمانيين وغير علمانيين على أهمية الاصلاح الديني ـ اصلاح الفكر الديني ـ لأي نهضة، والدارس لتاريخ النهضة الأوربية لابد ان يقف بتمعن أمام حجم وأهمية حركة الاصلاح الديني في تلك النهضة، والتي ما تزال تعطي مفاعيلها حتى هذه المرحلة. وقد جاء المشروع على مظاهر من محاولات الاصلاح الديني في المنطقة العربية، وخص بالذكر منها ما تجسد في جهود الأفغاني والكواكبي ومحمد عبده ومن ارتبط بهذا التيار، وهذا حق لكنه عرض مبتسر لأنه أعرض عن ذكر حركة اصلاح له السبق وتعتبر ذات تاثير مباشر على قائد عملية الاصلاح الديني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الشيخ محمد عبده. ونقصد هنا الحركة الوهابية.
لا اعلم ان احدا ذهب الى خلاف التأكيد أن دعوة محمد بن عبد الوهاب هي دعوة لتخليص الفكر الاسلامي مما علق به من الخرافات، وتحرير المجتمع الاسلامي مما ظهر به من بدع. قد يختلف الكثير في تقييم مسار هذه الحركة، وفي تقييم مآلاتها، لكن كونها ذهبت الى قلب العقيدة الاسلامية وجوهرها وحاولت أن تنقيها وتطلق طاقات الفكر الاسلامي الى آفاق جديدة فهذا مما لاشك فيه، ولقد ارتبطت بهذه الحركة ثلاث حقائق تاريخية :
الحقيقة الأولى: أن الدول العثمانية حاربت الحركة الوهابية، وجيشت من أجل ذلك الجيوش، وكان لمحمد علي حاكم مصر الجديد دوره الحاسم في قمع الوجه السياسي لهذه الحركة، عبر الحملة العسكرية التي قادها ابراهيم باشا في الجزيرة العربية واسفرت عن القضاء على الدولة السعودية الأولى.
الحقيقة الثانية: أن العديد من الدارسين يروا روابط فكرية وحركية واضحة بين الوهابية وكل من المهدية والسنوسية، رغم وجود خلافات في بعض الوجوه، ربط بعض الدارسين بين هذه الفروق وبين طبيعة البيئة التي وجدت فيها هاتين الحركتين اي ليبيا والسودان، والمهام التي كانت ظروف المجتمعين تطرحها،
الحقيقة الثالثة : انه إذا كانت الحركة الوهابية اصطدمت على وجه التحديد بالسلطة العثمانية، فإن المهدية والسنوسية، اصطدمتا وقاتلتا المستعمر الغربي الجديد، وبالتالي فإن هذه الحركات تصنف ضمن المجرى العام لحركة التحرر العربية.
إن المشروع الحضاري العربي يتوسل استنهاض أمة، وهو حتى يستطيع ذلك لابد لرؤيته أن تستوعب تاريخ هذه الأمة، والوقائع التي شكلت وما تزال وجدانها، وبنت مكونات القوى الناعمة وغير الناعمة فيها، أي قوى الفكر وقوى الحركة فيها. وأظن ان المشروع المطروح من هذه الزاوية قد افتقد لهذه الخاصية الجوهرية.
ثالثا : مكانة الاسلام في هذا الشروع :
والاسلام المعني هنا هو الاسلام الدين، والاسلام الحضارة والقيم، وإذ يكون واجبا أن نفرق مباشرة بين الدين والفكر الديني، فإن ما يجب التوكيد عليه والتوقف ازاءه أن انتماء دولة المشروع الحضاري العربي الى الإسلام ليس مجال بحث، وليس فكرة قابلة للمراجعة، إذ ان الاسم هنا هو أحد ركني هوية الأمة والركن الآخر هو العروبة، إن هذا يجب أن يكون واضحا وقاطعا، ولم يتضح على هذا النحو في المشروع المقدم.
إن الحديث عن التجدد الحضاري يبدأ من هنا بالتحديد، فلا تجدد حضاري إن لم يكن الاسلام عنوانا له، ولا يكفي القول بأن " نسق القيم النهضوي لابد أن يكون في الآن نفسه معبرا عن الشخصية العربية ـ الاسلامية، ومتمسكا بالقيم الكبيرة فيها المستمدة من التراكم الاجتماعي والثقافي والديني ( قيم التمسك بالعائلة، وأخلاق المروءة، والصدق، والإيثارعلى النفس، والتراحم ، والتوادد، والتضامن، والانصاف، والعدل...)، ومنفتحا على العصر منتهلا منه أرقى ما في قيمه ومتمسكا بها ، مستمدجا اياها في منظومته" كما لا يكفي ان نقول لاحقا إن الاسلام أضاف الى العرب قيما جديدة على قيمهم، ونستشهد بالحديث النبوي " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "، إن الأمر أوسع من ذلك بكثير. إن هذا الانتماء الى الاسلام لابد أن يكون ناظما لكل عناصر الأمة كما العروبة، وإن اختلفت مظاهر أو دوافع هذا الانتظام.
ينقل عن العلامة محمد مهدي شمس الدين قوله: إنه ليس في الأمة العربية أقليات بل أكثريات: أكثرية إسلامية يندمج فيها العرب وغير العرب، وأكثرية قومية يندمج فيها العرب المسلمون والعرب غير المسلمين. ولعل في هذا القول تجسيد لبعض أوجه ما أريد ايضاحه هنا. ثم إننا قد تتباين رؤآنا في ما يجب أن تباشره السلطة في الدولة المرجوة من واجبات تجاه الاسلام وتجاه العروبة، لكن يجب أن لانختلف فيما يجب على الدولة أن تقوم به وتباشره، أي في واجبات الدولة تجاه عنصري هوية الأمة. إن الدولة لايجوز لها أن تفرط في شيء من هذه الواجبات، لكن قد يكون للسلطة القائمة أولويات، والفارق بينهما أن الدولة ليست فقط السلطة القائمة التي يجسده النظام السياسي، أو الأغلبية الحاكمة، وإنما ايضا مؤسسات ومنظمات وقوى رسمية أو مدنية او اهلية تجسد مجتمعة الكيان الحيوي للدولة، واضرب على ما اقول مثلا من التجربة الناصرية، قد لانرى انشغالا كبيرا من القيادة الناصرية بالقضية الاسلامية وما تفترضه من أوجه نشاط، بل لعل أوجه النشاط الاسلامي الرئيسية للنظام السياسي كانت في مجال علاقات الدول، لكن الدولة المصرية كانت تقوم بدور مهم جدا في النشاط الاسلامي، ولقد أنيط بالأزهر الشريف القيام بالشطر الكبر من هذا الدور، وأجري عليه التعديلات والتطوير اللازم من أجل هذا الهدف، وتهيأت له الامكانات المادية للوفاء بهذا الدور، كان الأزهر بمؤسساته العلمية والفقهية والإرشادية والإعلامية وببعثاته في كل اصقاع الأرض، سهم الاسلام وقلعته في الدولة التي بناها عبد الناصر. والى جانب الأزهر كانت هناك مؤسسات أخرى وفرت لها الدولة مجالات وامكانات الحركة قامت بأدوار أخرى في هذا الأمر ومن مظاهر مكانة الاسلام في مشروعنا الحضاري ان يحمل هذا المشروع موقفا واضحا من الفقه الاسلامي" وهو ثروة الأمة القانونية، وملاط نسيجها الاجتماعي". والفقه هنا ليس الدين، كما أنه ليس شيئا خارجيا عن الدين، إنه فهم رجال لاحتياجات مجتمعهم على ضوء إدراكهم لمقاصد الشرع وحدوده وتعليماته ونصوصه، وقد يبدو الأمر هنا خاصا بالمسلمين في المجتمع العربي، والحق غير ذلك، فهذا الفقه يوفر للمسلمين وغير المسلمين، شرط الاستقلال الذي جعله المشروع الحضاري المطروح هدفا رئيسيا منبثا في كل جنباته، والفقه الاسلامي يوفر هذا الشرط من الجانب أو الزاوية القانونية، لقد تناول المشروع ضرورات الاستقلال الثقافي، وضرورات الاستقلال الاقتصادي، جنبا الى جنب مع تشديده على ضرورات استقلال الاراده السياسية، وتحرر الوطن سياسيا، وكان مهما وصائبا أن يشير في غير مكان ان الاستقلال المنشود في كل هذه الجنبات نسبي، كان في الماضي كذلك وهو اليوم نسبي أكثر مما كان بحكم تغيرات العصر متعددة الجوانب والتي يشار اليها اختصارا بالعولمة.
وأنا اتحدث عن هذا التراث الفقهي من هذه الزاوية وعلى هذه القاعدة ـ قاعدة النسبية ـ المتوفره في صلب القواعد والأصول الفقهية في الاسلام، كيف يمكن أن يكون القانون" الفقه " الروماني، أو الفرنسي، أو الأنكلوساكسوني، هو المرجع الرئيسي لدساتيرنا وقوانيننا، ويصبح هو ملاط حياتنا الاجتماعية، ولا يكون ذلك للفقه الاسلامي، ولعل التاريخ يقدم لنا الدلالة والدرس في هذا المجال تحديدا، فقد كان فرض القوانين الغربية بدلا عن الفقه الاسلامي في العلاقات الاقتصادية والقانونية والسياسية خطوة من أهم ثلاث خطوات اخذ بها المستعمر حينما غزا بلادنا، وذلك في محاولة منه الى اختراق بنية مجتمعاتنا، والتمكين له فيها، وقدم أخونا المفكر والباحث المميز"عوني فرسخ" جهدا شديد الأهمية والصلة بهذه المسألة في كتابه " الأقليات في التاريخ العربي".
والقضية في شأن الفقه أوسع بكثير وأعمق من مجرد تضمين أو عدم تضمين الدستور نصا بشأن مرجعية الشريعة الاسلامية، ذلك أنني أشاطر الدكتور سليم العوا ومن يسير على رأيه بأن القضية ليست في النص وإنما في التزام المجتمع وتوجهه العملي. وإذا كان هاجس المشروع النهضوي المطروح كله " أن تتحرر الأمة من القيود المفروضة عليها، وأن تضع يدها على ثروتها، وأن تستغلها لمصلحتها، ولما يحقق تقدمها وأمنها"، فإننا هنا أمام ثروة قانونية لاحدود لها، ولا يجوز التفريض بها، بل إن التفريط فيها يعتبر خطيئة يتراوح وصفها بين الجريمة الواضحة، وبين الجهالة الفاضحة.
ليس المطلوب هنا تنقية هذا الفقه، فشعار التنقية غير علمي، لأنه يغفل أحد جوانب هذا الفقه وهو الجانب التاريخي. المطلوب ممن يتقدمون لقيادة مشروع النهضة أن يعملوا مع كل القوى الفاعلة القادرة والمختصة على اطلاق حركة فهم وتمثل لهذا الفقه في إطار استهداف التوصل الى قوانين وتشريعات تستطيع ان توفر الأساس النظري لحركة النهضة، وتستطيع أن تنقل قوى المجتمع كلها الى هذه المرحلة، وتستطيع أن تمنع الاستغلال المخل للقضية الدينية أو توظيفها في الصراعات والخلافات بين القوى الاجتماعية والسياسية في المجتمع الواحد.
رابعا: المضمون الاجتماعي للوحدة :
مهم الى اقصى حد تبيان أن هدف الوحدة يجب أن يكون فوق الطبقات، والانقسامات الاجتماعية، وحين يصبح كذلك في حياتنا الوطنية والفكرية، تكون مجتمعاتنا العربية وقواها في مرحلة صحية على مختلف الصعد. الوحدة لايجوز أن تكون مادة خلاف بين قوى الأمة، يمكن وطبيعي أن تكون أشكال الوحدة مادة خلاف، يمكن وطبيعي أن يكون النظام الاجتماعي لدولة الوحدة مادة خلاف، فهذا وذاك جزء من برامج التغيير التي تسعى القوى السياسية في تطبيقها، وتختلف عليها وفيها. هذا طرح مبدئي سليم، ومن زاوية هذا الطرح، كان مفهوما أن تنفذ الراسمالية في الجمهورية العربية المتحدة انقلابا على نظام عبد الناصر، تغير فيه نظام الجمهورية العربية المتحدة، لكن تحافظ في الوقت نفسه على الوحدة القائمة، لو حدث هذا لكنا أمام وضع مختلف جذريا، لكن ذلك لم يحدث، وجاء الانفصال، بما يحمله من تدمير لدولة الوحدة خيارا للنظام الاجتماعي الاستغلالي القائم على التحالف المقيت بين الاقطاع ورأس المال المستغل والقوى الأجنبية. مهم أن نشير هنا أن الحركة الشعبية التي نهضت منذ اللحظة الأولى للإنفصال اطلقت توصيفها له وللقوى التي صنعته وساندته، وقالت عنها أنها القوى الرجعية، إن الموقف من الوحدة كان نفسه في العرف الجماهيري العام الموقف من نظامها الاجتماعي وخيارت هذا النظام وسياساته. أي أن الحس الجماهير كان قاطعا بأن صناع الوحدة هم صناع التقدم، وصناع الانفصال هم صناع التخلف، وفي عمق هذه الرؤية لم يعد مهما ماذا ترفع القوى المختلفة في الاصطفافين من شعارات، الشيوعيون، كما البعثيون الذين أيدوا الانفصال صاروا رجعيين مثلهم مثل القوى الطبقية المتخلفة.
صار معيار التقدمي أن يكون وحدويا، ومعيار الرجعي ان يكون انفصاليا، والسبب الرئيس في ذلك أن الحس الشعبي لم يتلمس أي بعد وحدوي قومي عند صانعي الانفصال، في حينها قالت أوساط عديدة من مفكرين وسياسيين ان الانفصال جاء ردا على الخطوات الاشتراكية التي خطتها دولة الوحدة، وكان هذا التحليل يريح الكثيرين لأنه يشدد على قضية التحول الاجتماعي، وأعتقد ان التدقيق في جهود إجهاض الوحدة يدلنا دون عناء أن العمل على اجهاض المسيرة الوحدوية لاصلة مباشرة له بتلك الخطوات الاشتراكية، لقد كان مطلوبا وقف عملية توحد الأمة، بأي طريقة ، وتحت اي عذر أو شعار. أنا من الذين يرون أن الخطوة الأولى في تعبيد طريق الانفصال كانت حينما تمكنت قوى داخلية ودولية من منع العراق من الانضمام الى الجمهورية العربية المتحدة، وبالتالي أوقفت كرة الثلج الوحدوية ومنعتها من مواصلة اندفاعها، مما أدى الى تحول حركة الوحدة العربية من الهجوم الى الدفاع، ومن التقدم الى الانكفاء. إن كل حديث عن أخطاء او ثغرات داخلية، أو تجاوزات، أو تكاليف وأعباء، نجمت عن عملية توحيد القطرين، وجعلها سببا في الانفصال، هو من قبيل عدم التصدي للأسباب الحقيقية، أو من قبيل الضعف الداخلي في الدفاع عن حركة الوحدة العربية، ولا أقول ذلك، لأنفي وقوع أخطاء، أوتجاوزات، أو أعباء، في تجربة قيام الجمهورية العربية المتحدة، وإنما لأقول إن مثل هذه الظواهر "ذاتية كانت أو موضوعية"، مما حدث ويحدث في كل عملية توحيد، في كل المراحل التاريخية: القديمة والحديثة والمعاصرة، ودون وجود أي استثناء، لكن مواجهة هذه يكون بالعمل من داخل دولة الوحدة، وبالنضال من أجل توليد آليات لمواجهة النقائص والثغرات والتجاوزات، وبالصبر على تحمل الأعباء.
يجب ان يكون واضحا أن الانجاز التاريخي،الاستراتيجي، لايتحقق دون ثمن، ولا يتحقق بالنيات الحسنة، ولا يتحقق خارج إطار المعارك المستمرة وتكاليفها على مختلف المستويات. أعود للفكرة الرئيسة التي بدأت بها وهي أهمية أن تكون قضية الوحدة قضية جامعة للأمة على مختلف تشكيلاتها، لكن هل هذه فرضية أم حقيقة اجتماعية، وهل هي ممكنة، أم غير ممكنة. هل طرحت قضية الوحدة وتشكلت لها اطاراتها من قبل اليمين أو اليسار أو الاسلام السياسي. القاعدة التي أتى عليها المشروع أن هذه هي ما يجب أن يكون، لكن لم يقدم دليلا على هذا الوجوب، واستثني هنا، مشروعي محمد علي، والمشروع الوهابي الأصيل، ولكل ظروفها، وطبيعتها في طرح القضية الوحدوية، لكن المنطقة العربية شهدت في حقيقة الأمر حركة توحد اقليمية قامت بها قوى سياسية مختلفة، وفي ظروف تاريخية محددة، وفي إطار توافق وطني ودولي في أحيان، ساهم في تحقيق هذا الانجاز، من هذه وحدة جزء كبير من جزيرة العرب تحت لواء العائلة السعودية، ووحدة ليبيا تحت لواء السنوسية، ووحدة امارات الساحل المتصالحة والتي تولد عنها قيام الامارات العربية المتحدة، وأخيرا وحدة جمهوريتي اليمن، وعلى أهمية هذه الانجازات، يجب أن نعترف ــ وقد أتى المشروع على هذا التوضيح ـ بالطبيعة الخاصة لها، وأنها جميعا لم تقم في إطار جهود لاقامة دولة للأمة العربية، لذلك فإن البحث فيها لابد أن يتم خارج نطاق الحديث عن الوحدة القومية وإن كان يمكن أن تكون داعمة لها. الحركات التي تولدت من النظم الاقليمية العربية في إطار تصور او مفهوم قومي كانت تلك التي تحدث عنها المشروع وهي : وهي مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلس التعاون العربي، وإتحاد المغرب العربي. ولقد كان ملفتا أن يذهب المشروع الى أنه " كان ممكنا أن تتحول التجمعات الفرعية الثلاثة الى نواة كبيرة لعملية التوحيد القومية، لو قامت على أمرها نخب سياسية مؤمنة بفكرة الوحدة".
إن هذه الخلاصة لاتستند الى الواقعة التي تتحدث عنها (أي هذه التجمعات) وإنما تأتي عليها لتذهب الى فرضية أخرى لاوجود لها على أرض الواقع، أيفرضية أن تتوفر لهذه التجمعات نخب سياسية تؤمن بفكرة الوحدة. إذ لو توفرت لهذه التجمعات تلك النخب المؤمنة بقضية الوحدة، لانتهت القضية، ولما كانت هناك مشكلة اساسية لا في العملية الوحدوية، ولا في عملية التنمية قطريا او قوميا، ولكان علينا نحن أن نعيد النظر في كل عملية التحليل والفهم لواقعنا الاجتماعي والسياسي إن هذا العرض، وهذا الاستدلال، غير واقعي وغير منهجي، لقد ولدت هذه الكيانات في أجواء البحث عن بديل لفكرة الوحدة العربية ولحركة الوحدة العربية، واستجابة من هذه النظم لرؤى خارجية، وحين تراخت تلك الرؤى، فقدت هذه الكيانات قوة الدفع التي بدأت بها. نحن لانعارض اي وحدة يمكن تحقيقها لهذه الأمة، باي شكل، وعلى اي مستوى، وفي إطار أي نظام، ونرى ـ كما تحدث المشروع ـ أن الوحدة يجب أن تكون هدفا لكل قوى الأمة وطبقاتها، ولكل تكويناتها السياسية والحركية، ولكن نثبت هنا رؤيتنا وتحليلنا المستند الى وقائع تاريخنا السياسي، والاجتماعي، لمن يستطيع أن يرفع هذا الشعار ويعمل ويضحي من أجله، ومن تتوافق مصالحه معه، وندعو ونعمل لأن تعي القوى السياسية العربية طبيعة هذا الشعار ومكانته في حياة الأمة ومستقبلها، وندعو وندفع لتوليد الآليات الثقافية والاقتصادية والسياسية التي من شأنها خلق محفزات في العمل الوحدوي، وتحقيق خطوات على طريقه سواء وعت القوى القائمة على هذه الآليات هذه الأبعاد الوحدوية لها أم لم تع .
خامسا : العولمة ومشروعنا النهضوي :
الحديث عن العولمة هو من أهم ما يمكن أن يتعرض له الباحث في مشروع النهضة، لأنه حديث عن المستقبل، يتصل بكل المفاهيم التي يطرحها المشروع النهضوي من الاستقلال الى الوحدة والديموقراطية، الى التقدم والعدل الاجتماعي. الى التجدد الحضاري. وهو من أخطر ما يمكن تناوله في هذا المجال لأنه حديث ملتبس، تتشابك فيه الحقائق الموضوعية مع حمولات القوى الاجتماعية الداخلية والعالمية التي تقود عملية العولمة، أو تسير مروجة لها، الى درجة يكاد لا يتبين الفارق بين هذا وذاك.
في خمسينات القرن الماضي كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أداة الولايات المتحدة في الهيمنة على مسار الدول الأخرى وفي المقدمة منها الدول النامية التي تبحث عن طريق للتقدم والنمو، الآن ومع انطلاق مرحلة العولمة صار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ـ على اقل تقديرـ جزءا من نظام العولمة في جناحيه الاقتصادي والاجتماعي، وقد أضيف لهما منظمة التجارة العالمية التي باتت تتحكم وفقا للقانون الدولي في كل شيء على صعيد الانتاج والتسويق والتبادل الاقتصادي، والفكري، والثقافي، حتى كأن الشعار الرأسمالي الأصيل " دعه يعمل يدعه يمر"، عاد ليسطع من جديدة لكن هذه المرة على المستوى الكلي للكرة الأرضية، وليس على مستوى الدولة القومية. ثم بدأت القوى الكبرى تتقدمها الولايات المتحدة تحاول توليد أو اصطناع نظام سياسي وقانوني دولي يتلاءم مع هذه التطورات، وكان من الطبيعي ان يشمل ذلك العمل على تغيير نظام الأمم المتحدة "وهو نظام ولد على نتائج الحرب العالمية الثانية التي تغيرت الان تغيرا جذريا".
علي مدار القرن العشرين، كانت هناك فرص وإمكانات لطرح وتحقيق خطط تنمية وطنية منعزلة أو شبه منعزلة عن تأثيرات الخارج، حتى صارت نظرية " تمويل خطط التنمية بالتضخم أو العجز" مما يدرًس في الجامعات ومراكز البحوث، لكن هذا لم يعد ممكنا، لقد تحقق نوع من التشابك بين المجتمعات والاقتصاديات في العالم الراهن لم يكن له مثيل، حتى ذهب البعض الى وصف عالم اليوم بأنه عالم القرية الواحدة،ولعل هذا في بعض أوجهه صحيح جدا. ولقد حقق العلم تقدما في كل مجالات الحياة: في نطاق الاتصالات والمواصلات، والاعلام، والحواسيب، وعلوم الطب والحياة، وعلوم الفضاء، وتطبيقاتها،..... مايعجز الانسان عن تصور آفاقه المستقبلية، لقد صارت وقائع التقدم العلمي تسبق في جوانب معينة الخيال. والى جانب هذه المظاهر للعولمة فقد انساح العالم تجاه بعضه بعضا، مخترقا الحدود والحواجز، وكان من نتيجة ذلك، ما عرف بأمواج الهجرة من الجنوب الى الشمال، وبروز ظاهرة الأمراض العابرة للقارات والأمم، والأزمات الاقتصادية الشاملة لكل الاقتصاديات على هذا الكوكب، والجريمة متعددة الأنواع العابرة للقارات، والتغير في المناخ الذي يلقي بظلال كيبئة على كل اقطار العالم نتيجة تضافر عوامل: الجفاف والفيضانات والعواصف.
وصار واضحا كنتيجة لهذه العولمة عجز الدول القومية منفردة على مواجهة هذه التغيرات، فراحت تسارع الى انشاء تكتلات اقليمية وقارية اقتصادية ومالية وأمنية، وراحت تبحث في اشكال التدخل متعدد الأطراف لمواجهة أعباء هذه
التغيرات. وفي خضم هذا التغير الهائل ـ الذي حول العالم الى" قرية صغيرة" ـ تحاول الولايات المتحدة أن تولد قيما ومفاهيم ونظما حاكمة تستطيع من خلالها إحكام سيطرتها على العالم الجديد، وحين تعجز عن تحقيق ذلك بقوة الإرادة الدولية التي تعمل على توجيهها، تفعل ذلك بقوة السلاح الذي تملكه، ومثال ذلك ما فعلته في العراق واحتلاله، وما تفعله الآن في افغانستان، وأماكن أخرى من العالم، ويتولى الكونغرس الأمريكي باعتباره ممثلا عن عقل النظام الأمريكي، ومركز القرار الاستراتيجي فيه، صوغ المفاهيم، والقيم، وتوليد المنظمات والهيئات الحاكمة لها، واطلاق الشعارات والعناوين الملائمة لها: من الحرب على الارهاب والاسلام، الى الحريات الدينية والسياسية والأخلاقية، الى الشرق الأوسط الجديد، وحينما يتحرك المجتمع الدولي في إطار لايتوافق مع مصلحتها المباشرة في هذه المرحلة تضرب به عرض الحائط ثم تستخدمه في مواجهة الآخرين كما حدث مع المحكمة الجنائية الدولية. هذا هو مشهد العولمة في أضيق صورها وأكثرها مباشرة، ويمكن إضافة الكثير الى هذا المشهد، والسؤال الذي لابد لمشروع النهضة من أن يجيب عليه؟ ما تأثير هذه العولمة على الأهداف الرئيسة لهذا المشروع، وكيف يتعامل معها؟!
ما تأثير العولمة على التنمية المستقلة، والعدل الاجتماعي، ودور القطاع العام وقيادته لهذا المشروع، ومطالب امتلاك الأمة لعناصر القوة وفي مقدمتها التكنولوجيا بكل مستوياتها: النووية، الفضائية، الجينية، الدوائية، والزراعية، وكذلك مطلب توفير الأمان الغذائي، والصحي للأمة. ما موقف مشروع النهضة من منظومة القيم كلها المطروحة في إطار هذه العولمة، من دعوى الديموقراطية، الى دعاوى إعادة بناء المجتمعات على قاعدة الانقسام الطائفي والعرقي، الى مطلب تغيير المفاهيم الدينية والتعليمية التي لاتتفق مع موجبات هذه العولمة، الى المطالبة بتغيير شكل مؤسسة الزواج، وذلك بقبول الشذوذ الجنسي باعتباره ليس فقط خيارا شخصيا، وإنما آلية لولادة أسرة معترف بها قانونا، واعتبار الدعارة مهنة من المهن الاجتماعية التي يجب تنظيمها واحترامها وصون حقوق العالمين فيها من خلال مؤسسات مهنية شأن غيرها من المهنـ وليس التصدي لها باعتبارها اشاعة للفاحشة، واستغلال لجسد المرأة، وتحويلها الى مجرد سلعة في سوق العرض والطلب، الى إعتماد مفهوم خاص للإستهلاك، وحتى لنوعية الانتاج قائم على التغير والاستبدال السريع، الى اعتبار حجم الثروة هي معيار تحديد مكانة الفرد في المجتمع، ومقدار حظه في المنتج الاجتماعي، وفي توجه الاستثمارات ومجالاتها، مما يعني انتفاء مفهوم العدل الاجتماعي ، وانتفاء دور الدولة والمجتمع في تأمين هذا العدل وحراسته، ويدخل في هذه المفاهيم حتما قبول هيمنة الفكر الصهيوني التوراتي على العالم، واعتباره المرجع القيمي للمجتمع الدولي القائم والقادم.
علينا أن نحدد بدقة ما إذا كان كل ما سبق هو العولمة باعتبارها حركة تاريخية موضوعية، وبالتالي فإن الدعوة الى مقاومتها تكون نوعا من العبث غير المجدي، ولا يكون من ثماره الا زيادة تخلفنا، ودفعنا المزيد من الأثمان خلال عملية المقاومة غير المجدية، أم أن ما تقدم من توصيف للعولمة ينقسم في حقيقته الى شطرين رئيسيين: **شطر موضوعي لايمكن لاحد أن يغفل عنه ولا أن يعانده، واقصى ما يمكن في هذا الجانب هو برمجة التعامل معه، وفق الامكانات وما تتيحه ظروف المجتمع، وحتى هذه فإنها لا تتجاوز حدا معينا. ** وشطر ذاتي يتمثل في مجموعة القيم والاستهدافات والنظم التي ولدتها القوى المتحكمة ودفعت بها مروجة أنها جزء اصيل من العولمة، ووليد طبيعي لها بحيث لايمكن قبول التقدم التكنولوجي في كل اشكال النشاط الانساني الذي حقق مفهوم العولمة في مختلف مظاهر الحياة، مع رفض منظومة القيم هذه لتزيد من تحكمها في العالم، إن من المهم لأقصى حد أن نملك الرؤية الواضحة: الصحيحة والدقيقة، في
التفريق بين هذين الشطرين. لابد أن نفرق بين المكونات الأصيلة لقطار العولمة، وبين الحمولة التي وضعتها نظم الاستغلال والهيمنة العالمية في هذا القطار مستهدفة أن تزيد من سطوتها وهيمنتها، وتبعية الأخرين لها اقتصاديا وثقافيا وروحيا.
ثم كيف يمكن لأصحاب مشروع النهضة أن يتحركوا في هذا العالم، لتحقيق اهدافهم، كيف لهم أن تعاملوا مع قطار العولمة يستفيدوا مما يعطيه مع منجزات في تجميع قوى الخير في عالم اليوم، لتحقيق أغراض النهضة. في النصف الثاني من القرن العشرين، كانت هناك صورة مغايرة، لكنها مقيدة ايضا، مقيدة للتصور ومقيدة للتحرك، فالعالم كان مقسوما الى معسكرين، وعلى كل دولة أو أمة أن تختار موقعها في هذا المعسكر أو ذاك، لكن ارادة التحرر استطاعت أن تبدع طريقا آخر، طريقا ثالثا، متحررا من هذا المعسكر وذاك، لكن غير منعزل عنهما، وجاءت دعوة عدم الانحياز، والتحرر الوطني، لتجلي هذا الطريق، واستطاعت دول عديدة أن تصل الى مرحلة التقدم، وتعتق نفسها من حالة التخلف والتبعية، استنادا الى هذا الخيار ـ ولقد هزمنا نحن، وهزم مشروعنا الذي كان مرافقا للمشروع الهندي، والصيني ـ نجحت أمم عديدة في تحقيق أهدافها.
الآن نحن أمام ظرف جديد كليا، أمام حكومة عالمية تشكل وتدار من مركز رئيس تمثله الولايات المتحدة، وتحاول أن تنفرد فيه، أو تجعل نفسها في موقع القيادة فيه ـ على اختلاف رؤى الحزب الحاكم في هذا البلد ـ فكيف يرى وكيف يتحرك أصحاب مشروع النهضة؟ وإذا كانت الاجابة عن سؤال يتصل بالقوى الاجتماعية القادرة على حمل مشروع النهضة هو أول ما يجب على أصحاب المشروع أن يجيبوا عليه، فإن تحديد كيفية التحرك في ظل هذا الواقع الدولي لتحقيق أهداف هذا المشروع هو السؤال الثاني الجوهري والحاكم على قدرة الحركة وعلى فعالية الحركة أيضا. ولست هنا في موقع تحديد هذه الرؤية ـ أي الاجابة على هذا السؤال ـ لكن يمكن تقديم إشارات تساعد في الوصول اليها، إشارات ولدها فهم هذه العولمة، وفهم طبيعة مشروع النهضة :
1ـ تماما كما جاء في نص المشروع النهضوي " فإن القضية المطروحة في إطار تحليل التجليات الثقافية للعولمة هي الدعوة الى بناء ثقافة كونية تتضمن نسقا متكاملا من القيم والمعايير لفرضها على الشعوب، مما قد يؤثر على الخصوصية الثقافية للشعب العربي"، وليس هناك من تعديل على هذا النص غير حرف التقليل "قد" ذلك أن النجاح في رفض هذه التجليات الثقافية للعولمة سيؤثر بالتاكيد على الخصوصية الثقافية للشعب العربي. فكيف نواجه ذلك ؟!. هنا نستعيد ما سبق أن طرحناه في سياق الحديث عن الاسلام، والفقه الاسلامي، والقيم الاسلامية الجامعة، هنا يصبح التمسك بهذه المرجعيات ليس شأنا دينيا فقط ـ على أهمية هذا الشأن ـ وإنما ضرورة استقلالية لمواجهة زحف هذه القيم التي يتحدانا بها قطار العولمة، أي يصبح طرح والتزام هذه المعايير قضية وطنية وقومية عامة، لاتخص المسلمين وحدهم في المجتمع العربي، وإنما تمتد لتشمل كل العرب الذين يؤمنون بضرورة أن يكون لهذه الأمة مشروعها النهضوي. أنا هنا لاأتكلم عن قيم ( الشجاعة، والكرم والمرؤة، والصدق ، والمساواة، .. الخ) وإنما أتحدث عن قيم (التوحيد، والاستخلاف، والتسخير، والاستقلالية، والعدل، والحرية، والتميز، والتنوع الانساني، والمسؤولية تجاه بني البشر على اختلاف ألوانهم، وأممهم، ودياناتهم)، وهي قيم نجدها في كل رسالات السماء وجاءت في الاسلام على أكمل وجه، باعتباره خاتم الرسالات.
لقد كان ملفتا أن يطرح المشروع حين حديثه عن بعض آليات تعزيز العدالة الاجتماعية " تفعيل دور الزكاة ومؤسسة الوقف"، لأن هذا الطرح يحمل في جوهره نقيضين، فهو يكشف احساسا بأهمية الزكاة في تعزيز اليات مكافحة الفقر، وهذا صحيح، لكنه يتناول هذه القضية من هذه الزاوية فقط دون الانتباه الى أن الزكاة، ومؤسسة الوقف معا، هما جزء من منظومة "المشهد الاجتماعي للدين"،وهي في تجليات عديدة تغطي كافة أبناء الأمة على اختلاف دياناتهم، وبالتالي يجب أن يدرس وضعهما كجزء من مؤسسات المجتمع، وأداة من أدواته في تحقيق استهدافات مشروع النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي زيادة اللحمة الوطنية بين ابنائه.
2ـ إعادة برمجة علاقة قوى مشروع النهضة بالعالم الاسلامي، دوله وقضاياه، واحتياجاته، والعمل على صوغ علاقات مباشرة مع القوى السياسة والمنظمات الأهلية والمدنية فيه، والعمل على صوغ تحرك مشترك إزاء كل هذه القضايا.إن هذا العالم الذي انتهض بقوة وإصرار، دفاعا عن هويته الاسلامية، وعن فلسطين، وضد الهيمنة الأمريكية الغربية، وواجه بالسلاح الهجوم الأمريكي الغربي عليه، يستأهل منا أن نضعه في صلب رؤيتنا للمستقبل، وفي صلب خططنا في الحركة والعمل، ودون التوقف عند صحة أو خطأ ما نراه من تحركات لهذه القوة الاسلامية أو تلك إزاء هذا الحدث أو ذاك، فإن النظرة الاستراتيجية هي تلك التي تستطيع أن ترى هذه القضايا في بعدها الحقيقي طويل الأمد، وليس في لحظتها الراهنة، إن الحراك الشعبي في تركيا ـ كمثال ـ يستأهل الوقوف أمامه طويلا، ودراسته، واستخلاص الدروس منه، فالقضية هنا ليست في موقف الحكومة التركية ـ على أهميته الكبرى ـ ولكن في ذلك المزاج الشعبي التركي الذي فجرته مسائل عديدة تحتل القضية الفلسطينية مكانا مهما فيها، فكشف عن مخزون هائل وفاعل في اتجاه انسجام حركة هذا البلد الاستراتيجية مع هويته وتاريخه ودينه، وليس صعبا أن نكتشف مثل هذا المخزون في اندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، ومجموع البلدان الاسلامية. إن الوطن العربي محاط من اقصاه الى اقصاه، بدول اسلامية لها تاريخ مشترك مع هذه الأمة، وتقوم مجتمعاتها على قيم مشتركة، وعلى بنى نسج اجتماعية مشتركة مع هذا الأمة بل إنها بفعل المكانة الخاصة للأمة العربية في دعوة الاسلام، وفي حركيته العربية، فإن هذه الدول وشعوبها تكن تقديرا خاصا للأمة العربية، تقديرا يمثل في حد ذاته مصدر قوة، وحزام أمان يمكن تفعيله والاعتماد عليه، بل نحن أحوج ما نكون اليه في ظرف العولمة الراهن.
3ـ إن عولمة المجتمعات ولد قوى اجتماعية، وحركات اجتماعية، مناهضة للآثار السلبية للعولمة، وهي قوى يزداد وزنها عالميا، وتعبر عن نفسها بتحركات ومؤتمرات وتجمعات لها أهميتها وتأثيرها، ولابد لمن يريد أن يواجه هذه العولمة أن يستفيد من هذه الظاهرة وأن يكون ـ على نحو ما ـ جزءا منها، وهو ما يستدعي من قوى المشروع النهضوي أن تجعل لقوى المناهضة للعولمة مكانا في ثقافتها، وفي حركتها، وأن تعتمد برامج تؤهل قواها للتفاعل مع هذه القوى .
ويجب أن نلاحظ هنا أن هذا يستدعي ـ فيما يستدعي ـ أن ندرك اولويات تحركنا واستهدافاتنا، فهذه القوى تحمل من التناقضات الشيء الكثير، واغفال ترتيب الأولويات قد يؤدي الى إهدار فاعلية هذه القوى إن لم نقل التصادم معها، لقد قدمت تجربة المقاومة الفلسطينية في غزة، وتجربة حركة غزة الحرة واسطول الحرية، مشهدا شديد الكثافة لما نطرحه هنا. إن هذا التحرك للضمير الانساني أحدث آثارا خطيرة في المجتمع الانساني، لأنه موجه مباشرة لواحدة من أهم عصارات العولمة، وهي الحركة الصهيونية، والكيان الصهيوني، التي تريد أن تكون الحاكمة للقيم الانسانية، والمرجع المعتد لها، ولعل في الاستشهاد ببعض ما كتبه ممثل اليمين الراسمالي المتصهين رئيس الوزراء الاسباني الأسبق خوسيه ماريا ازنار كشف قاطع لأثر هذا التحرك على هذه العولمة ، فقد كتب هذا الرجل في صحيفة التايمز البريطانية محذرا من خطر التزحزح عن القيم الصهيونية تحت ضغط هذه القوى المناهضة يقول: " إن الغرب يمر في مرحــلة ارتباك حول شكل مستقبل العالم، سببها، الشك المازوشــي في هويتنــا الخاصة... والتعددية الثقافية التي تجبرنا على الركوع أمام الآخرين... أن نترك اسرائيل لمصيرها الآن، سيظهر مدى غرقنا، ومدى صعوبة علاج انهيارنا،إن اسرائيل هي جزء أساسي من الغرب وما هو عليه بفضل جذوره اليهودية ـ المسيحية، ففي حال تم نزع العنصر اليهودي من تلك الجذور وفقــدان إسرائيل، فسنضيع نحن أيضاً وسيكون مصيرنا متشابكاً وبشــكل لا ينفصم سواء أحببنا ذلك أم لا." وقال أزنار: إن أحداث "أسطول الحرية" لا يجب أن يستدرج الدول الغربية إلى الانفعال تجاه الكيان الصهيوني ، أو اتخاذ مواقف خاطئة تضر بالكيان الصهيوني .
4ـ تدقيق النظر في خارطة دول العالم الراهنة، وخياراتها، وتكتلاتها،وهو تدقيق سيكشف بسهولة أن هناك دولا تشق طريقا صعبا خارج نطاق استهدافات العولمة التي تقودها الولايات المتحدة, ولكل من هذه الدول سبيلها، وسرعتها، وظروفها، ومصالحها، ومدى قربها أو بعدها عنا، وتشمل هذه القائمة طيفا واسعا من الدول: من إيران وتركيا وحتى فنزويلاومن الصين وحتى جنوب افريقيا، ومن ماليزيا، وصولا الى روسيا. إن دول هذا الطيف تحمل مشاريعها الخاصة، وهي بالتأكيد على درجة من التناقض مع هذه العولمة التي تقودها واشنطن وتمثل خطرا داهما علينا، وقد يكون هذا التناقض واضحا لالبس فيه، كحالة ايران وفنزويلا وأمثالهما، وقد يكون تناقضا غير واضح، أو أن المرحلة لاتكشف أبعاده، كحالة الصين وروسيا. وفي كل هذه الحالات لابد أن يكون لأصحاب مشروع النهضة رؤيا وموقف، وأن يكون لهم انحياز، وفهم للتناقضات الطبيعية التي يمكن أن تظهر بين مصالح هذه الدول ومصلحة الأمة العربية، التي بحساب الدول والكيانات غير موجودة، بل الموجود منها أنظمة تابعة في الغالب للقاطرة الأمريكية وخانعة لمطالب بل ولتطلعات هذه القاطرة. إن علينا العمل على دعم وتاييد تكتل هذه الدول وتعاونها، وعلى أصحاب مشروع النهضة أن يجدوا لهم موطئ قدم في التشكيلات التي يمكن أن تصدر عن هذه التكتلات، من خلال منظمات المجتمع الأهلي التي ينشئونها، ومن خلال التحركات الشعبية القومية والدولية التي يشاركون فيها، ومن خلال أي إطار مهني أو طبقي أو إنساني يتولد عن هذه التكتلات، إن إقامة الصلة المباشرة مع هذا النوع من التحرك الدولي من شأنه أن يضع لنا وزنا على خريطة هذه الدول، وعلى جدول أعمالها، ومرة أخرى فإن فلسطين، وتحرك القوى الشعبية الدولية لدعم مطالب كسر الحصار عن غزة، تقدم المثل، فقد استطاع النضال الشعبي المثابر والمجاهد، أن يضع نفسه على جدول أعمال كل الدول، وكل المنظمات، وكل التكتلات.
سادسا : مشروع النهضة : الحامل الاجتماعي للمشروع.
يكاد يكون المشروع خاليا من تحديد القوى الاجتماعية والطبقية الرئيسية التي يستهدفها، ويرى أنها القادرة على القيام بأعباء النهضة، وتملك المصلحة في ذلك.
لا شك أن مشروع النهضة يستهدف الأمة بكل مكوناتها،لا أستثني أحدا، لكن هذا لايعني أن جميع مكونات الأمة وقواها تقف في الموقع نفسه في هذا المشروع.
نحن نتحدث عن نهضة أمة، عن أعباء يجب أن تحمل، عن معارك شديدة القسوة، لابد أن تخاض،عن أولويات لابد من اعتماده. ومن طبائع الأشياء، ومن حقائقها، ان نجد من يقف مع هذا المشروع ومن يقف ضده، من يضع روحه ودمه في سبيله ومن يتآمر عليه، ويحاول تعطيل حركته ووأده، ولقد راينا ذلك في كل مشاريع النهوض، وفي كل المحاولات التي تبذلها الأمم على وجه البسيطة، فمن يقف مع مشروع النهضة العربية المطروح؟. من من القوى والطبقات الاجتماعية، قبل الأحزاب وتشكيلات الوعي الاجتماعي والسياسي التي تقف مع هذا المشروع؟. في تجربة جمال عبد الناصر تحددت هذه القوى بتحالف عريض، سمي حينها "تحالف قوى الشعب العامل"، وقد نشأت الدولة في حينها وفي ظرفها التنظيم السياسي لهذا التحالف، ووضعت له ضوابطه ، ثم راحت بين الحين ولآخر تطور فيه، وتعدل عليه، وتسعى لتفعيله، نحن في إطار الفكر القومي، المتفهم للطبيعة الخاصة والتاريخية لتلك التجربة، والمتمثل لتقدم الفكر الديموقراطي على المستوى الانساني كله، اخذنا بنهج العمل الديموقراطي، واعتبرناه السبيل الأمثل لمعرفة الخيار الشعبي الحقيقي ،وكذلك الطريق الأمثل لتحقيق أهدافنا، مفترضين أن الناس إذا تركوا لخياراتهم الصافية فإنهم سيقفون الى جانب القضايا التي تقوم عليها حركتنا: الوحدة العربية الديموقراطية، التنمية المستقلة، العدالة الاجتماعية، الاستقلال الوطني،والتجدد الحضاري، وقبلنا ضمنا اعتبار ان موقف شعبي مناهض لبرنامجنا دليل على ضعفنا أو خطئنا في تجسيد هذا البرنامج.
لكن نهج العمل الديموقراطي الذي نتمسك به، لا علاقة له بذلك التحليل المطلوب الذي يكشف لنا، من يقف مع مشروعنا ومن يقف ضده، إذا كنا هنا نتحدث عن الأفراد، عن كل شخص بعينه، فإن وعي كل فرد، هو الذي يحدد موقعه، ونكون مطالبين حينئذ أن نتتبع كل فرد لنعرف موقفه وموقعه، وهذا ليس منطق الرؤية التحليلية للمجتمع، وإنما هو منطق العمل الحزبي، منطق تجنيد الأعضاء والأنصار، وإذا كنا نتحدث عن قوى وطبقات وتشكيلات إجتماعية فالأمر مختلف جدا، لابد أن يكون هناك تحديد واضح للقوى الرئيسة القادرة على حمل اعباء النهضة، والتي تملك المصلحة في ذلك، وحين يتم تحديد هذه القوى يأتي العمل السياسي والاجتماعي والثقافي، أي تأتي مهمة الأحزاب وغيرها من تشكيلات الوعي لتعرف هذه القوى أو بعض شرائحها على مصلحتها إن ظهر أنها لاتدرك هذه المصلحة، أو لاتدركها القدر الكافي. في برنامج الثلاثين من مارس 1968 حدد جمال عبد الناصر المعيار المعتمد لمكانة كل فرد في المجتمع، معيار القيمة والمكانة، فجاء في تحديده للخطوط الرئيسية التي يقترح ان يتضمنها الدستور الدائم المنتظر بعد إزالة آثار العدوان"ان يعتبر العمل هو المعيار الرئيسي لقيمة الفرد في المجتمع".
ومنذ أن هزمت الثورة الناصرية صارت الثروة ـ ايا كان مصدرها ـ هي معيار القيمة الانسانية والاجتماعية، من يملك هو من يسيطر وهو من يتقدم الصفوف، وهو من تقام المشروعات لخدمته، بل إن قيمة الشيء صارت محددة بسعرها في السوق، بغض النظر عن مصدر هذه القيمة ومن تخدم، ووصل الأمر مثلا بان اعتبر الرئيس المصري الراحل انور السادات أن ارتفاع سعر الأراضي عشرات الأضعاف عن سعرها السابق، هو دليل من أدلة التقدم، بل هو دليل على ارتفاع قيمة مصر، أي أن قيمة الوطن تحولت الى قيمة سوقية.
نحن في مشروع النهضة أين نقف من هذه المفاهيم والمعايير؟. لقد كان ضعيفا الى أقصى القول " أن كل تعيين مبدئي لقوى افتراضية ( قوى الشعب العاملة، الأمة، النخبة، الكتلة التاريخية...الخ) قد يصطدم بوقائع اجتماعية معاكسة، أو قد يسقط من الحسبان قوى جديدة أو صاعدة ربما يرشحها الواقع لأدوار كبيرة، ولذلك ، فإن أهداف المشروع النهضوي وقضاياه ستظل تنتج قواها الاجتماعية التي تحملها حين تجد مصلحة فيها. ومن الضروري في هذا السياق ضمان مساندة الجماهير العربية للمشروع".
ما المنهج المعتمد الذي اوصل الى مثل هذه الرؤية وأنتج مثل هذا النص؟!، أين دروس التاريخ، والتجارب: تجاربنا نحن وتجارب الشعوب في هذه المسألة؟!. ثم كيف ستنتج أهداف المشروع القوى الاجتماعية التي تحمله، من أين ستأتي هذه القوى ، إن لم تأت من المجتمع ومكوناته، من الأمة وقواها؟!. إن هذا التحليل غير المنهجي عكس طبيعته على الكثير مما ورد في هذا المشروع، ولعل آخر ما نلاحظ ذلك في الفقرة الأخيرة التي تحدد "كيف نجسد هذا المشروع، ولقد جاءت اقرب الى طريقة التفكير وتجارب العمل التي سبقت تطور الفكر الاجتماعي، وتجاربه، ودروسه.
سادسا : وقفة مع بعض الاحكام والمعايير المعتمدة.
هناك بعض المفاهيم والقيم والأحكام منبثة في غير مكان من النص المطروح تحتاج الى توضيح، والى حسم، ذلك أن أي غموض فيها ليس من شأنه أن يعطي فرص بناء وتقدم حقيقي، إن الوضوع في الطرح والرؤية هام جدا لمثل هذا المشروع، هو أهم بما لايقاس من قوة سبك العبارات، أو جمالياتها. إننا نريد من مشروعنا أن يحرك الأمة ومكوناتها، والأمة فيها من التنوع وتباين المستويات، واختلاف الثقافات، مالا يستجيب لمقتضياته الا الواضح الذي لاشبه فيه. وقد يكون من الصعب تتبع كل المفاهيم والأحكام والقيم التي تحتاج الى مراجعة أو توضيح في هذا المشروع، لذلك سأكتفي بالوقوف عند بعضها:
1ـ السلطنة العثمانية: الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية، هل كانت بالنسبة لنا دولة مستعمرة، كما البريطانيون والفرنسيون وغيرهم لاحقا. أم كانت دولة اسلامية كما الدول الاسلامية أو السلطنات الاسلامية أو دول الخلافة الاسلامية السابقة لها.؟ التساؤل هنا ليس من قبيل دراسة التاريخ، وإصدار أحكام على بعض مراحله، وإنما من قبيل تمكين من يستهدفهم المشروع من تملك رؤية حقيقة متسقة وغير متناقضة مع مكونات شخصيته التي تصنعها عوامل الثقافة والتاريخ والعقيدة. والتساؤل يستدعي التدقيق في معنى الشرعية التي تكتسبها كل سلطة ويكتسبها كل حكم،ومن أين تصدر هذه الشرعية ومن يوفرها ويتوافر عليها، ما الفارق من زاوية المشروعية بين السلطنة العثمانية، والسلطنة الأيوبية، أو الحكم المملوكي، ولا أريد ان ارجع هنا الى المقارنة بين الخلافة العثمانية، والخلافة العباسية والأموية، وذلك لأسباب تاريخية وفقهية توفرت للخلافتين ولم تتوفر للخلافة العثمانية، وليس هنا مجال بحث ذلك. ومما يدعم ما أشير اليه هنا أنه ـ في حدود معرفتي ـ لم يتخذ أحد من المصلحين والسياسيين والقوى المنظمة موقفا من شرعية الدولة العثمانية الا بعد أن سيطر الاتحاديون على الدولة العثمانية وبدؤا عملية التتريك، أما قبل ذلك فقد شارك الجميع، جميع القوى والمفكرين في المشرق العربي في دعوات ومحاولات اصلاح الخلافة العثمانية، وساهموا في آخر أو أبرز هذه المحاولات الممثلة في تشكيل مجلس المبعوثان.
وقد استثني من هذا التعميم حركتين: الوهابية، ومحمد علي اللتين كانتا تحملان في داخلهما مشروعا بديلا للسلطة العثمانية، لكنهما كانا يستمدان مشروعيتهما من المكان نفسه الذي استمدت السلطنة العثمانية المشروعية منه وهو الاسلام.
2ـ التراث والحداثة، الأصالة والمعاصرة : وليس المقصود هنا اللفظين او المصطلحين ذاتهما، ومدا توفرهما في هذا النص، وإنما معنى ودلالة هذين المصطلحين، والذي بدا وكأن حركة الأمة صعودا وهبوطا، وحركة مثقفيها وقواها في العصر الحديث مرتبطة بهذين المصطلحين، واعتقد أن في الأمر لبس شديد، وأن المرحلة التي كان كثير من الحوار يدور حولهما قد مضت، وقد صار من المهم توضيح مدلولات كل مصطلح، وما يجسد، كما صار مهما اعادة النظر في وقائع " ومعارك فكرية وأدبية صنفت في باب الصراع بين الحداثة والتراث، ولم يكن هذا التصنيف دقيقا ، كما لم يكن على اطلاقه حقيقيا. لقد تحدث المشروع عن عوامل اخفاق تجربة النهضة الأولى المتمثلة بتجربة محمد على وجعلها في ثلاثة، وقال " وثالثها تراجع الفكر الاجتهادي الاصلاحي، منذ مطلع القرن العشرين، بعد غياب محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وانقلاب محمد رشيد رضا على الحركة الاصلاحية الاسلامية، في عشرينات القرن الماضي، مع بداية تنظيره لدولة الخلافة الاسلامية على حساب الدولة الوطنية، ولقد طال هذا التراجع الفكر الليبرالي ذاته أمام هجوم الفكر المحافظ: وتعد محاكمة كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي، وكتاب الاسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق مثالا على هذا الهجوم" إن عرض الأمر على هذا النحو والاحتفاظ بالاحكام والأجواء التي ولدتها، يجزم بأن الذي انتصر هنا هو قوى التراث والمحافظة، على قوى التجديد. أو قوى الأصالة على قوى الحداثة، وهذا غير حقيقي، ويجب على مشروع الأمة أن يقدم رؤية أخرى لتلك المعارك والمواجهات فيها تدقيق بمكونات كل مرحلة، والمخاطر التي تحيط بها، والقوى التي تؤثر فيها، ودوافع قوى الأمة في اتخاذ هذا الموقف أو ذاك، وما لم نفعل هذا بدقة ووضوح، فقد يلتبس الوضع مستقبلا على كثيرين فنجد فسحة في الفكر والحركة لمن يصف القوى التي تقف الان مع الاحتلال في العراق بدعوى الديموقراطية، أو مع الاحتلال في افغانستان بدعوى التنوير، بأنها القوى المعبرة عن الديموقراطية والتنوير والتقدم، القضية كما تبدو لي هي في كيف نجعل قوى الأمة على اختلاف اولوياتها تصب طاقاتها في مسار واحد، وكيف لايتحول مطلب حق وحاجة مثل مطلب الديموقراطية، والتقدم والعدالة وحقوق الانسان الى منافذ تدخل منها القوى المعادية للأمة.
3ـ الشورى والديموقراطية
وهذا موضوع شديد الأهمية لكن تناوله على الشكل الذي تم لم يكن محكما ولا يتناسب مع طبيعة هذا المشروع، إنني أتفق مع ما ورد في المشروع من أن "تعاليم الدين الاسلامي زودتنا بمبادئ ترتبط في محتواها بالمبادئ عينها التي قام عليها النظام الديموقراطي" لكن الدخول في متاهة العلاقة بين الشورى والديموقراطية، والجزم بأن الشورى" ملزمة وليست معلمة"، هو تناول متعجل، وانتزاع لموقف ونص من سياقه الحقيقي وإنزاله في غير مكانه، أو محاولة لإظهار الاحاطة بموضوع يشغل التيار الاسلامي والقومي معا، والاحاطة بما يحيط به من اشكالات، وهي محاولة لا تجوز في مثل هذا المقام. إن الشورى مفهوم، وسمة من سمات المجتمع الاسلامي، هكذا طرحت في القرآن الكريم، وهكذا تناولتها السيرة النبوية، وهكذا مارسها مجتمع المسلمين الأوائل، الشورى الاسلامية ليست نظاما، حتى تكون ملزمة أو غير ملزمة، والحديث عن الإلزام فيها قد يتناول عملية الشورى، وقد يتناول نتائج عملية الشورى. وتاريخيا كانت هناك محاولات في العهد الراشدي لتوليد نظام في اطار الحكم والعمل السياسي مستندا الى سمة الشورى لكن هذه المحاولة وئدت سريعا.
هناك فرق واسع بين المفهوم وبين محاولة توليد نظام لهذا المفهوم في نطاق الحكم والعمل السياسي، والمفهوم لاصفة تاريخية له، وإنما قوته في أنه حكم "قيمة ومعيار"وليس كيانا وتجربة تخضع للنقد وللتكامل أو التشويه أي لحركة الفعل ورد الفعل، حركة النمو والتراجع. كيف تكون الشورى ملزمة، وهي في جوهرها سعي لجعل أي قرار مستند الى أوسع رؤيا وأصحها، هي جمع للعقول حتى يأتي القرار صحيحا من وجوهه المختلفة. وحققيا للمصلحة على أي وجه تبدت، سعي غير محدد الاليات، وغير محدد التوقيتات، وغير محدد الجهات الملزمة به. لقد جعل الله جل وعلا مفهوم الشورى سمة من سمات العقل الناضج الصحيح، ومكون من مكونات الفطرة السليمة، لذلك لم يربطه بالعقيدة، ومن هنا نفهم تقديم الله جل وعلا لملكة سبأ نموذجا حيا لمن يشاور ابتغاء اتخاذ الموقف السليم.
4ـ نمط بناء الوحدة:
ليس في هذا المشروع فقط، وإنما في الكثير من الدراسات والمراجعات للفكر الوحدوي وللحركة الوحدوية، يصار الى الحديث عن استخلاص درس ونتيجه مهمة، وهي أن الصيغة الأمثل لدولة الوحدة هي الصيغة الاتحادية، وتقدم هذه النتيجة باعتبارها الخلاصة والدرس من التجارب والمراجعات. ولا شك أن الصيغة الاتحادية هي الأمثل والأفضل، ليس للأسباب التي أوردها النص من أنها " تقوم من اجتماع الكيانات العربية وتراضيها على مؤسسات إتحادية مشتركة تنتقل اليها السلطة الجامعة مع استمرار سلطاتها المحلية، وفي كل الأحوال لابد أن يكون الاطار الاتحادي القومي محل تراض وتوافق بين الكيانات والقوى القومية العربية كافة".إذ يوحي النص على أن الوحدة الاندماجية لاتقوم على التراضي والتوافق بين الكيانات والقوى القومية العربية كافة، وإنما لأسباب أخرى نفسية واجتماعية وبرامجية،وقد تكون تاريخية ودينية وقومية ايضا، تتصل بالتركيبة الاجتماعية والاقتصادية والدينية لكل قطر عربي. وما أريد أن أقف عليه هنا ليس في الحديث عن الأفضل والأمثل، وإنما في ارجاع هذاالأفضل والأمثل الى المراجعات والدراسات والخبرات المتولدة عن التجارب السابقة، وكأن تلك التجارب بنيت على قاعدة الوحدة الاندماجية، وفي هذا الافتراض اشارة كامنة تعتبر أن اندماجية الوحدة " الممثلة في الجمهورية العربية المتحدة" كانت من أسباب قيام الانفصال، وفي هذا تجاوز عل حقائق التاريخ وممالأة لقوى ليست بالأصل وحدوية، ولا تعني لها المسألة القومية شيئا، بل إنها قوى مضادة ومعادية للحركة القومية.
لقد قامت الجمهورية العربية المتحدة في الظروف التاريخية التي قامت بها، لكنها في كل الأحوال لم تكن، أو لم تصبح اندماجية أبدا، قد يعتبر البعض أن الوقت لم يسمح لها بذلك، واستطيع القول استدلالا من تشكيل الوزارات الاقليمية، واستمرار استقلال النقد، واستمرار وجود جيشين شبه مستقلين عن بعضهما، أن التوصيف الدستوري لدولة الجمهورية العربية المتحدة لم يكن اندماجيا، كما لم تتحقق له وصف الدولة الاتحادية، وإنما كانت حالة تتأرحج بينهما، ثم أن التفكير بمد هذا التصور لشكل الدولة الى اقطار عربية أخرى كانت مرشحة للإلتحاق بالدولة الوليدة لم يكن بالقطع قائما على اساس الدولة الاندماجية"، لم يكن مطروحا أن يكون العراق عقب ثورة 14 تموز 1958 جزءا من دولة اندماجية، بل أكثر من ذلك لم يكن مطروحا لاحقا أن يكون التحاق اي دولة ظروفها الاقتصادية غير ظروف مصر وسوريا ومن شابههما مرتبطا بكون نظامها الاقتصادي أو خيارها الاقتصادي هو الخيار الاشتراكي، وجاءت محاولة الوحدة الثلاثية، عام 1963 بين مصر وسوريا والعراق على قاعدة الدولة الاتحادية، ثم حينما تكررت المحاولة ثانية عام 1971 " وكان النظام في مصر لايزال يؤكد تمسكه بنهج وخيارات عبد الناصر" جاءت في إطار الدولة الاتحادية، واعلن قيام اتحاد الجمهوريات العربية، بين مصر وسوريا وليبيا.
ما أريد أن أثبته هنا أن الوصول الى فكرة "الدولة الاتحادية" لم يكن نتيجة مراجعات، ونتيجة نظر في اسباب الانقلاب على دولة الجمهورية العربية المتحدة، ولا نتيجة جهود فكر بذلت من قبل هذه الجهة اوتلك بعد أن ذوى الوهج الوحدوي، تماما كما أنه لاصلة على الاطلاق بين الانفصال وبين شكل دولة الوحدة، تماما كما لم يكن هناك صلة حقيقية بين الانفصال والنظام الاقتصادي لدولة الوحدة. وهنا يجب الجزم بعدم جواز تقديم صيغ وخلاصات متوهمين أن من شأنها أن تجمع أكثر عناصر وقوى الأمة، إن الذي يجمع هو الحقيقة فقط، الحقيقة في رؤية وقائع التاريخ، والحقيقة في رؤية مكونات الواقع الاجتماعي والسياسي والروحي لأمتنا.
5ـ مكتسبات مشاريع النهضة السابقة وتراكماتها:
تحدث المشروع عن"البناءعلى مكتسبات مشاريع النهضة السابقة، وتراكماتها"، وهو توجه ضروري في أي عملية بناء، والاستفادة من دروس تجربتي النهضة في مطلع القرن التاسع عشر، ومنتصف القرن العشرين،ـ وليس كما ورد في نص المشروع مطلع القرن العشرين ومنتصفه ـ، أي تجربة محمد علي ، وجمال عبد الناصر، مما أشار اليه المشروع وحرض عليه. ولعل من أهم ماكشفت عنه التجربتين هو الدور المركزي لمصر في إحداث النهضة على المستوى القومي، والاستهداف المباشر لهذا الدور من قبل القوى المضادة، يقينا منهم أن انكفاء مصر الى الداخل يعني سقوط كل محاولة لها للبناء والتقدم.
المشروع النهضوي العربي لم يعط هذا الدرس أهمية، لم يتباه ولم يبن عليه، ولم يقدم البديل له، لقد بدأت الهزيمة الحقيقية للمشروع القومي الناصري بخروج الدولة المصرية من معادلة الانتماء القومي. وهو خروج لم يسفر فقط عن هزيمة مشروع عبد الناصر، وإنما عن فقد مصر لأي دور أو قوة أو قدرة على بناء شيء ايجابي، في الداخل الوطني، أو في المحيط الإقليمي، وتحولت على الفورإلى قوة معطَلة ومعطِلة. لقد تحدث عبد الناصر في فلسفة الثورة عن دور يهيم في المنطقة يبحث عمن يحمله، دور قيادي وريادي، وقد خلص الى أن القدر أهًل مصر للقيام بهذه المسؤولية، أي أن حقائق الجغرافيا، والسياسة، والتاريخ، والتكوين السكاني، والتراكم المعرفي، جعل من هذا البلد رافعة أمته، ولا مناص أمامه من أن يقوم بهذا الدور، ولا يقوم بذلك فضلا ومنة، وإنما مسؤولية وحفاظا على نفسه ومستقبله. أن طبائع الأشياء هنا هي التي تحكم هذا الدور، وحين ندرس تجارب العمل السياسي الوحدوي الحزبي او الفكري في المنطقة العربية والتي انطلقت من أكثر من بلد عربي، ندرك ان بعضها قام على مفهوم مغاير معتقدا أن بإمكان حركات الوعي : التنظيمي / الحزبي، او الفكري التوعوي، ان تتجاوز طبائع الأشياء، وان تستبدل بها ما تفرضه هذه الحقائق من دور مركزي لمصر.
هل يرى اصحاب مشروع النهضة أن حركة الوعي المنظم التي تمثلها الأحزاب وبرامجها وتحالفاتها، أقوى من ظواهر الحركة التاريخية التي تستند الى طبائع الاشياء؟!. إن لم يكن الأمر كذلك فأين تجسد هذا المفهوم المركزي في النص المطروح؟.
لقد اختتم المشروع بالقول: "لم تعد الأمة العربية أمام ترف الاختيار بين ممكنات عديدة، إنها أمام خيارين، لاثالث لهما: إما أن تنهض وتتقدم وتنفض عنها حالة التأخر والتقهقر، وإما ستزيد عروتها تفككا ونسيجها تمزقا، وفكرتها العربية الجامعة اندثاران إن النهضة اليوم أكثر من خيار ، هي فريضة وجودية، ودون القيام بها سقوط وانحلال".
ورغم جلال هذه الخاتمة فإن إيماننا العميق أن هذه الأمة ستقف على قدميها، ولا يمكن لها أن تسقط ، وتنحل، رغم كل ما تمر به.
إن النقص والخطأ والضعف في القوى السياسية وقوى الوعي، التي يفترض أن تحمل مهمة القيام بها، وحين لاتستطيع هذه فعل ذلك فإنها ستفرز قوى بديلة وآليات بديلة قادرة على النهوض بها، الأمر ليس خيارا، إنها طبيعة الأشياء، وأحكام القدر،وفرائض الدين والتاريخ والجغرافيا السياسية.
الشارقة